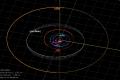عبدالنبي الشعلة **
خلال زيارتي الأخيرة إلى سلطنة عُمان الشقيقة، وتحديدًا إلى العاصمة مسقط، كانت المدينة لا تزال تعيش تداعيات حدثٍ أثار نقاشًا واسعًا في الشارع وفي وسائل التواصل الاجتماعي؛ حين احتشد جمعٌ غفير من أبناء الجالية الهندوسية للاحتفال بمهرجان "الديوالي"؛ عيد الأنوار وبداية العام الجديد في التقويم الهندي القديم. هذا العيد، في جوهره، تقليد اجتماعي تراثي يرمز إلى انتصار النور على الظلام والخير على الشر، ويحتفل به الهندوس في كل أنحاء العالم، ومن بينهم الجالية الهندية الكبيرة المقيمة في عُمان.
وقد أقيم احتفال بهذه المناسبة في حديقة العامرات عامة بولاية العامرات، غير أنّ مشاركة أعداد من المقيمين الهنود وظهور مجسّمٍ لبقرةٍ ضمن فقرات الاحتفال، أثارا جدلًا واسعًا بين مؤيدٍ رأى في المناسبة باعتباره دلالة إيجابية على الانفتاح الثقافي، ومعارضٍ اعتبرها تجاوزًا للحدود الرمزية في بلدٍ عربي مسلمٍ.
امتلأت المنصات الرقمية بتعليقاتٍ متباينةٍ وبلغةٍ متزنة في معظمها، لكنّ الحدث بدا غريبًا على المجتمع العُماني المعروف بتوازنه وهدوئه وتمسّكه بقيم التسامح واحترام التعدّد.
وبهدف احتواء الجدل وتطويقه تدخل سماحة مفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي- حفظه الله- ببيانٍ نشره عبر منصة “إكس” أعرب فيه عن استنكاره لما اعتبره “تقديسًا لما يُعبد من دون الله”، ودعا المسؤولين إلى “وقفةٍ تمنع كل دخيلٍ من بث سمومه في المجتمع”.
كثيرون قرأوا بيان المفتي لا بوصفه اعتراضًا على مبدأ التعايش الذي عُرفت به عُمان؛ بل محاولةً لإطفاء جذوة الجدل ووضع حدٍّ للتراشق اللفظي الذي بدأ يهدد سكينة الشارع، وهو ما تحقق فعلًا بعد صدور البيان؛ إذ هدأت الأصوات المتباينة، وسادت مجددًا الروح العُمانية الهادئة المتزنة التي نعرفها جميعًا. إن العُمانيين كانوا قد نجحوا في صوغ هويتهم الخاصة التي تجمع بين الأصالة والانفتاح، وبين الاعتزاز بالدين الإسلامي واحتضان التنوّع البشري. لذلك، لم يكن غريبًا أن يُثار النقاش حول مدى اتساع مظلة هذا التسامح في الحاضر، لا سيما في ظلّ التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة كلها.
وعلى مر السنين وتكرار زياراتي لسلطنة عُمان الشقيقة كونتُ علاقات وثيقة وحميمة مع حلقة متسعة من الأصدقاء العُمانيين، من كبار المسؤولين ورجال الأعمال ووجوه المجتمع وأعلام الثقافة والصحافة وغيرهم.
وكعادة وأريحية العُمانيين المعروفة؛ ففي كل مرة أزور فيها مسقط فإن هذه المجموعة تستضيفني على مأدبة عشاء أو غذاء يتم خلالها تبادل للأفكار والرؤى حول التطورات التي تشهدها المنطقة ومناقشة قضايا الشأن العام والمواضيع الاقتصادية والثقافية وما شابه.
في هذه المرة كان الموضوع الذي نوقش على مائدة الغذاء هو إشكالية العلاقة بين العمالة الوافدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي: كيف ينظر كل طرف إلى الآخر؟ وما الذي تغيّر في هذه العلاقة بعد عقودٍ من الاعتماد المتبادل في مجالات الاقتصاد والخدمات والتنمية؟
إنَّ الخليج العربي يتميز بواقعٍ سكانيٍّ فريدٍ على مستوى العالم؛ إذ تُشكِّل الجاليات الوافدة في بعض دوله أغلبية السكان، وأحيانًا بفارقٍ كبير عن عدد المواطنين. هذا الاختلال الديمغرافي لم يكن وليد الصدفة؛ بل نتيجة طبيعية للتنمية السريعة التي شهدتها المنطقة منذ اكتشاف النفط، وما استتبعها من حاجةٍ ملحّة إلى أيدٍ عاملةٍ أجنبيةٍ في مختلف القطاعات.
لكنّ خصوصية التجربة الخليجية لا تقف عند هذا الحدّ؛ فأنظمة الإقامة والعمل للأجانب فيها محكومةٌ عادةً بعقودٍ محدّدة المدة، ترتبط بصاحب العمل الذي يُطلق عليه “الكفيل”. وهو من يتولّى استقدام العامل ويتعهد بإعادته إلى بلده بعد انتهاء عقده أو عند فسخه. وحتى وقتٍ قريب، لم يكن يُسمح للعامل الأجنبي بالانتقال من جهة عملٍ إلى أخرى إلا بإجراءاتٍ معقدة أو موافقة الكفيل.
هذا النظام وإن كان قد وفّر آلية لضبط سوق العمل، إلّا أنه حرم العامل الأجنبي من حرية التنقل المهني، ومنح صاحب العمل سلطة شبه مطلقة؛ الأمر الذي جعل كثيرًا من العمالة الوافدة تعيش في دائرة القلق وعدم الاستقرار النفسي والاجتماعي.
في مقابل ذلك، يحمل المواطن الخليجي مخاوف لا تخلو من الوجاهة، تتعلق بالحفاظ على الهوية الوطنية والثقافة المحلية، خصوصًا مع ارتفاع نسب المقيمين إلى مستوياتٍ غير مسبوقة. وهناك أيضًا بُعدٌ اقتصادي يتعلق بمنافسة العمالة الوافدة للعمالة الوطنية في بعض القطاعات. وهكذا يتبادل الطرفان الشعور بالقلق، كلٌّ لأسبابه الخاصة: العامل خوفًا من الفقد، والمواطن خشيةً من الذوبان.
لكن الواقع يُثبت أن الجانبين شريكان في معادلة واحدة: العامل الوافد هو محرك أساسي لعجلة الاقتصاد والتنمية، والمواطن هو من يمنح هذه العملية معناها ووجهتها. ومن هنا، يصبح الحل في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، لا في القطيعة أو الرفض.
وفي حديثي مع مضيفيَّ في مسقط، لمسْتُ إدراكًا عميقًا لدى النخبة العُمانية بأهمية تطوير هذا الملف على أسسٍ إنسانيةٍ متوازنة؛ فالعُمانيون، بحكم تاريخهم وتجربتهم الطويلة في التعامل مع الشعوب والثقافات المختلفة، قادرون على تقديم نموذجٍ راقٍ لإدارة التنوع الديمغرافي والثقافي في الخليج.
لقد اتفق الحاضرون على أن العمالة الوافدة، رغم ما تمثله من تحدٍّ سكاني وثقافي، أصبحت جزءًا من نسيج المجتمعات الخليجية، وعنصرًا لا يمكن الاستغناء عنه في المرحلة الراهنة؛ فهي لا تُسهم فقط في الاقتصاد؛ بل تُغني الحياة اليومية بتنوعها الثقافي والإنساني، ما دام هذا التنوع محكومًا بالقانون والاحترام المتبادل.
لقد غادرتُ مسقط وأنا أستعيد مشهد الجدل الذي أثاره احتفال الديوالي، والنقاش الهادئ الذي دار على المائدة العُمانية العامرة. وفي ذهني سؤالٌ مفتوح: كيف يمكن لدول الخليج أن توازن بين ضرورات التنمية الاقتصادية وحماية الهوية الوطنية؟
الإجابة- في رأيي- تكمن في تحويل التنوّع إلى مصدر قوةٍ لا إلى مصدر قلق، وفي استثمار وجود هذه الجاليات كجسرٍ للتواصل الإنساني والثقافي والاقتصادي بين الخليج والعالم؛ فالتعايش ليس شعارًا؛ بل مسؤولية مشتركة تحتاج إلى وعيٍ مجتمعيٍّ دائم وإدارةٍ رشيدةٍ للتنوع.وهذا ما برعت فيه عُمان على امتداد تاريخها، حين جعلت من التسامح قاعدةً ومن الاعتدال نهجًا ومن التعددية سمةً للهوية العُمانية.
** كاتب بحريني